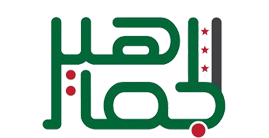محمد سلام حنورة.
في زمنٍ تحوَّلت فيه وسائل التواصل الاجتماعي إلى مرآة كبرى تعكس وجوهنا وتعيد تشكيل وعينا، لم تعد الإعلانات مجرد وسيلة لترويج سلعة أو خدمة، بل غدت خطابًا ثقافيًّا ينفذ إلى عمق السلوك والقيم.
من يتأمّل مضمون الرسائل الإعلانية المنتشرة على صفحات السوريين، خصوصًا في مدنٍ كحلب، سيجد أنها تجاوزت حدود التسويق، لتصبح جزءًا من التربية اليومية غير المعلنة.
الإعلانات اليوم لا تبيعنا منتجًا فحسب، بل تبيعنا فكرة، وترسم لنا نموذجًا لما يجب أن نكون عليه: أنيقين، سعداء، ناجحين، ومُرفَّهين. لكنها، في الوقت ذاته، تُربّي داخلنا نزعة استهلاكية تُقنعنا أن قيمتنا فيما نملك لا فيما نحن عليه.
يتربّى المتلقي على قاعدة جديدة: اشترِ لتصبح أفضل، وشيئًا فشيئًا تتراجع قيم القناعة والبساطة أمام هوس الاقتناء والمظهر.
وفي زحمة هذا الضجيج البصري، تتسرّب إلينا قيم أخرى أكثر خفاءً: فالإعلان الذي يبالغ أو يجمّل أو يَعِد بما لا يتحقق، يُعلّمنا الكذب والمراوغة دون أن نشعر.
تكرار هذا النمط يجعل الخداع يبدو “ذكاءً”، والمبالغة “تسويقًا ناجحًا”، وهكذا يتسلّل سلوك التزييف إلى تفاصيل حياتنا اليومية: في العمل، في العلاقات، في الحوار.
ثم يأتي دور الشك، إذ يغدو الجمهور الذي خُدع مرارًا جمهورًا مرتابًا، يشكّ في كل كلمة، وكل مبادرة، وكل وعد. إنها دائرة مغلقة من الخداع والتشكيك، تبدأ من رسالة إعلانية وتنتهي بعلاقات اجتماعية مهزوزة.
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فحين يُعاد تعريف السعادة والنجاح وفق منطق السوق، يصبح الإنسان منتجًا في سوق الصور، يقيس ذاته بعدد الإعجابات لا بعمق القيم. من هنا يبدأ التآكل الصامت في البنية الأخلاقية للمجتمع: تتراجع الصراحة، تُستبدل الشفافية بالتحايل، وتتحول المصلحة إلى معيار العلاقات.
ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الجانب المضيء. ففي حلب، مثلاً، ما تزال بعض الحملات المحلية تستخدم التراث والموروث كجسر للتواصل، فتعيد إلى الأذهان نكهة المدينة ودفء هويتها. هذه النماذج تثبت أن الإعلان يمكن أن يكون أداة تثقيف وبناء لا تزييف وتفكيك، متى ما انطلق من مسؤولية اجتماعية لا من منطق الربح وحده.
في النهاية، يبقى السؤال معلّقًا: هل نملك نحن — كمتلقين — مناعة فكرية كافية لتمييز ما نراه؟ أم أننا ما زلنا نسمح لكل إعلان أن يعيد صياغة قيمنا، ومعها شكل حياتنا؟